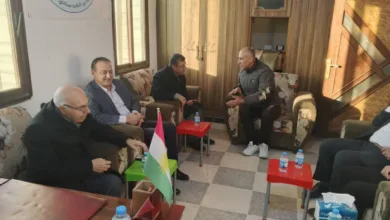الديمقراطية التشاركية شرط قيام الدولة في سوريا

بكر صدقي
الديمقراطية هي الكلمة الغائبة الحاضرة في سوريا اليوم، أو لنقل إنها الحاضرة بتغييبها المتعمد على لسان أركان سلطة دمشق ودعاتها وإعلامها. وحين يستحضرها أفراد قلائل سرعان ما يتم الرد عليهم بالكلام عن أولويات ملحة تدفع بها إلى مراتب الترف والأحلام البعيدة. فالبلد مدمر وممزق بين مناطق نفوذ لجيوش أجنبية مستقرة، وأعزل أمام الاعتداءات الإسرائيلية، والشعب جائع ومفكك… إلى آخر هذه القائمة الطويلة من الاستحقاقات التي تجعل من الحديث عن الديمقراطية قفزاً فوق الواقع وامكانياته.
بل أكثر من ذلك، الديمقراطية ليست وصفة سحرية يمكن تطبيقها في كل مكان وزمان بصرف النظر عن الشروط المتعينة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بعد مسار تاريخي طويل يكتسب خلاله الناس وعياً يؤهلهم لممارستها، بعيداً عن الانتماءات والعصبيات التي تشدهم إلى الوراء وتحرمهم من هذا الوعي.
تقوم كل هذه التبريرات على أساس أن ثمة دولة تقودها سلطة سياسية لديها وعي شامل بمنظور تاريخي يقود الأمة إلى خلاصها. أو هناك «عقل الدولة» التي تسمو على الأفراد كما على الجماعة الوطنية ككل، «تعرف مصلحتها» وما على الشعب إلا السير خلف تلك القيادة الحكيمة لتحقيق غايات التاريخ المدركة لديها.
واقع الحال أن سوريا التي تحررت من جحيم النظام الأسدي وهدمت دولته الطغيانية، فشلت إلى اليوم في تأمين المقومات الأولية لدولة جديدة على أنقاضها، بل إنها ماضية نحو مزيد من التفكك وتكاد لا تعرف إلى أين هي متجهة. فالجماعة التي استولت على السلطة وقدمت نفسها للمجتمع الدولي على أنها ستقود المرحلة الانتقالية، فنالت منه التشجيع والمساندة، لم تقدم للسوريين رؤيتها لسوريا المستقبل، وقامت بمجموعة من الخطوات الهادفة إلى شرعنة وجودها في السلطة، لم تحظ بإجماع وطني. حين يبدأ المرء بعقد أزرار قميصه بدايةً خاطئة، فسوف يتراكم الخطأ مع جميع الأزرار، فيضطر إلى فكها والبدء من الصفر. وقد بدأت السلطة تلك الخطوات بما أسمته «مؤتمر النصر» الذي اجتمع فيه قادة الفصائل العسكرية واتفقوا على تسمية أحمد الشرع رئيساً للجمهورية، في حين تولى بعض دعاة «حكم السنة» إطلاق شعار «من يحرر يقرر!» وكأن السجع في العبارة يكفل صحتها ويغني عن الشرعية الوطنية التي لا يمكن الحصول عليها إلا بأوسع مشاركة في السلطة.
بدلاً من ذلك استمرت السلطة في عقد الأزرار على التسلسل الخاطئ نفسه، فعقدت على عجل ما أسمته بمؤتمر «حوار وطني» لم نسمع بأحد يدافع عن جدارته، بما في ذلك أشد المدافعين عن السلطة. إلى أن وصلنا إلى مجازر الساحل، تلتها مجازر السويداء، اللتين أديتا إلى شرخ شاقولي بين السوريين من المستبعد التئامه في ظل السلطة القائمة التي شجعت «الفزعات» و«النفير العام» والنزعة «الأموية» و«دمشق لنا إلى يوم القيامة»! وتسترت على خطف النساء العلويات والدرزيات، وأنكرت حدوث عمليات الخطف. وتحت ضغط الدول المحتضنة للسلطة تظاهرت بأنها ستحاسب المرتكبين في «أحداث الساحل».
يتكرر سؤال سوريا إلى أين في كل يوم، ولا تملك السلطة جواباً عليه غير الوعد بتدفق المساعدات والاستثمارات، بعد النجاح في رفع العقوبات، وتحويل سوريا إلى سنغافورة جديدة!
أظهرت المظاهرات الاحتجاجية للعلويين، الأسبوع الماضي، كم أن سوريا بعيدة عن البداية الصحيحة التي كان يفترض أن تبدأ قبل عام من الآن، بل هي ماضية إلى مزيد من التفكك المجتمعي والجغرافي. كانت العقبة الظاهرة أمام وحدة سوريا والسوريين، إلى ما قبل ذلك، تتمثل في منطقتي شمال غرب سوريا ومحافظة السويداء، وكانت جماعة السلطة تعتبر «قسد» و«الهجري» هما الخصم الذي يجب تطويعه. الآن أضيف إليهما العلويون والشيخ غزال غزال! وكأن كل شيء سيتم حله إذا تخلصنا من هؤلاء الانفصاليين. لكن السلطة ومؤيديها إنما صنعوا، من حيث لم يريدوا ذلك، زعامةً فئوية جديدة، الشيخ غزال، لتضاف إلى زعامتي قسد وحكمت الهجري. فعموم العلويين كانوا قد قبلوا بالسلطة الجديدة بعد انهيار نظام الأسد، حتى لو كان ذلك على مضض. ثم جاءت مجازر الساحل، وأرادوا طي صفحتها للمضي قدماً، لكن الانتهاكات استمرت بحقهم على أساس طائفي، وصولاً إلى الهجوم البوغرومي على أحيائهم في مدينة حمص في أعقاب جريمة مقتل زوجين في قرية زيدل، كان واضحاً أن الهدف منها افتعال فتنة طائفية.
رداً على مظاهرات العلويين دعت السلطة إلى مظاهرات حاشدة «للتعبير عن وحدة الشعب السوري» حسب أحمد الشرع، لكن المتظاهرين خرجوا للتهجم على العلويين وتهديدهم! ويستمر مؤيدو السلطة في شيطنة الدروز والعلويين والكرد (أو الهجري وغزال وقسد!) على وسائل التواصل الاجتماعي. لا نعرف كيف يمكن «توحيد الشعب خلف القيادة الحكيمة» في هذه الأجواء المسمومة.
منذ الأيام الأولى أظهرت السلطة أنها تنظر إلى السوريين كـ»مكونات» وليس كمواطنين في دولة ينتظم بعضهم في تيارات سياسية وأيديولوجية، وإذ دفعت بتلك المكونات إلى التبلور وفرز قيادات تعبر عنها، بصرف النظر عن الرأي فيها، تمت شيطنة تلك القيادات. في حين رفضت التعاطي مع تيارات أو تشكيلات سياسية بحجة انتظار صدور قانون للأحزاب ربما بعد سنوات! (مقابل إنشاء «إدارة سياسية» على عجل بقيادة وزير الخارجية، اتخذت مقرات حزب البعث المنحل مقرات لها!)
الديمقراطية لا تبنى بترسيخ البنى الأهلية، لا جدال في ذلك. لكن السلطة أغلقت كل قنوات التعبير عن معارضة وطنية، فكانت تلك المكونات هي البديل الوحيد لممارسة الضغط المعارض.
من هذا المنظور يمكن التأكيد بأن الديمقراطية ليست ترفاً، بل شرطاً لبناء الدولة في سوريا على أنقاض نظام الأسد المخلوع. فهي وحدها ما يمكن أن يجمع شتات المجتمع الذي مزقته سنوات الصراع وعمقت شروخه مجريات السنة الأولى من عمر سلطة دمشق. وإذا كان مفهوماً رفض السلطة لمفهوم الديمقراطية بالنظر إلى عقيدتها التي تعتبرها شركاً وكفراً، فمن غير المفهوم رفض «التيار الأموي» لها إذا كانت واثقة أن أي انتخابات عامة ستكرس سلطة الأكثرية السنية لأنها أكثرية. هذا بغض النظر عن أن الديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع تفرز غلبة الأكثرية على الأقلية. فهي تفترض قبل ذلك وجود دولة عمومية تمثل كل السوريين، فيها فصل بين السلطات وقانوناً يتساوى أمامه المواطنون. هذه ليست مطالب طوباوية تقفز على الشروط القائمة، بل هي الشرط الشارط لقيام الدولة.