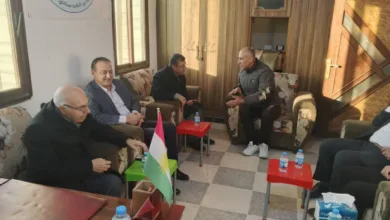الأكراد في سوريا: تاريخ الوجود وصراع الاعتراف

بثينة عوض
المدن:11/1/2026
لم يدخل الأكراد إلى سوريا بوصفهم موجة لجوء طارئة، ولا كجماعة عابرة على تخوم الدولة، بل كانوا ــ وما زالوا ــ جزءاً أصيلاً من نسيج اجتماعي وجغرافي تشكّل قبل قيام الدولة السورية الحديثة بقرون. حضورٌ رسخته الجغرافيا، وكرّسته أنماط العيش المشترك، وسبق في وجوده حدود الكيانات السياسية التي ستُرسم لاحقاً.
ومع ذلك، لم يتحوّل هذا الوجود التاريخي إلى اعترافٍ سياسي متكامل، ولا إلى تمثيلٍ قانوني يعكس ثقله السكاني ودوره الاجتماعي. ظل الأكراد حاضرين في المكان، في الزراعة والمدينة والذاكرة المحلية، لكنهم غائبون عن الدولة بوصفها إطاراً للحقوق والمواطنة المتساوية.
هكذا، بقيت العلاقة بين الأكراد والدولة السورية محكومة بسؤالٍ معلّق لم يُحسم منذ الاستقلال: كيف يمكن لجماعةٍ أن تكون جزءاً من التاريخ والجغرافيا، وأن تعيش في قلب البلاد، لكنها تبقى خارج سردية الدولة، وخارج تعريفها الرسمي للهوية والانتماء؟
جغرافيا بلا اعتراف
ينتشر الأكراد السوريون أساساً في الشمال والشمال الشرقي من البلاد، في رقعة جغرافية متصلة تمتد من الجزيرة العليا في محافظة الحسكة، مروراً بمدن وبلدات مثل القامشلي، عامودا، الدرباسية، وعين العرب (كوباني)، وصولاً إلى عفرين في الشمال الغربي. وإلى جانب هذا التوزع المتماسك، يحتفظ الأكراد بحضور قديم ومتجذّر في مدن كبرى مثل حلب ودمشق، حيث شكّلوا جزءاً من النسيج الحضري والاجتماعي منذ عقود طويلة.
لا يمكن اختزال هذا التوزع في كونه نتاج تحوّلات القرن العشرين وحده، أو نتيجة لحركات نزوح متأخرة، بل هو امتداد تاريخي لوجود كردي راسخ في بلاد الشام، ارتبط بأنماط حياة مستقرة، وبالعشائر، والزراعة، ومسارات التجارة القديمة التي ربطت الجبال بالسهول، والريف بالمدينة.
كان هذا الوجود، في جوهره، وجوداً محلياً مندمجاً، لا يقوم على الفصل الحاد بين “أقليات” و”أكثريات”، ولا يعرف الحدود الصلبة للهويات كما ستفرضها لاحقاً الدولة القومية الحديثة.
غير أن هذا الاندماج الاجتماعي والجغرافي لم يُقابله اعتراف سياسي مماثل. فالجغرافيا التي احتضنت الأكراد قروناً لم تتحوّل إلى أساس لحقوق واضحة، وبقي الحضور الكردي، رغم عمقه واتساعه، خارج التصوّر الرسمي للدولة عن الهوية والانتماء. هكذا تشكّلت مفارقة مستمرّة: جغرافيا ثابتة بلا اعتراف، ووجود راسخ بلا تمثيل.
الأكراد في العهد العثماني
خلال الحكم العثماني، لم يُنظر إلى الأكراد بوصفهم قضية سياسية مستقلة، ولا كجماعة قومية تسعى إلى كيان خاص بها، بل جرى التعامل معهم كجزء من نظام إداري واجتماعي أوسع، يقوم على الولاءات المحلية والبنى العشائرية، ويُدار وفق منطق الضبط والاستقرار أكثر مما يُدار وفق معايير الهوية.
في ذلك الزمن، لم تكن القومية إطاراً ناظماً للسلطة أو للحكم، ولم تُشكّل الانتماءات الإثنية معياراً فاصلاً في العلاقة بين الدولة ورعاياها. ما كان يعني الإدارة العثمانية هو القدرة على حفظ الأمن، وتأمين الطرق، وجباية الضرائب، وضمان حدّ أدنى من الولاء السياسي. ضمن هذا السياق، تمتع الأكراد بهوامش متفاوتة من الحكم الذاتي المحلي، ونسجوا علاقات مع السلطة المركزية تقوم على التوازن والمصالح المتبادلة، لا على الصدام المفتوح.
عاش الأكراد، بذلك، ضمن توازنٍ هشّ لكنه عملي: لا دولة قومية تمثلهم أو تتحدث باسمهم، ولا سلطة مركزية تسعى إلى إنكار وجودهم أو صهرهم قسراً في هوية واحدة. كان حضورهم معترفاً به بوصفه واقعاً اجتماعياً وجغرافياً، لا قضية سياسية تحتاج إلى حل.
غير أن هذا التوازن لم يكن قابلاً للاستمرار. فمع تفكك الإمبراطورية العثمانية في مطلع القرن العشرين، وولادة الدولة الحديثة بحدود صلبة وهوية قومية واحدة، انهار الإطار الذي سمح بتعايش التعددية دون اعتراف رسمي. ومع انتقال المنطقة من منطق الإمبراطورية إلى منطق الدولة القومية، تحوّل الوجود الكردي من واقع مُعاش إلى سؤال سياسي مفتوح، سيلازم سوريا الحديثة منذ نشأتها.
بداية “المسألة الكردية”
مع فرض الانتداب الفرنسي على سوريا عقب الحرب العالمية الأولى، بدأ الوجود الكردي ينتقل من كونه واقعاً اجتماعياً محلياً إلى ما سيُعرف لاحقاً بـ”المسألة الكردية”. فإعادة رسم الخرائط السياسية للمنطقة، وما رافقها من اتفاقيات دولية، أدّت إلى تقسيم الامتداد الجغرافي الكردي بين أربع دول ناشئة، وجعلت أكراد سوريا أقلية داخل كيان وطني جديد لم تتبلور هويته بعد.
في هذا السياق، لم يكن الأكراد وحدهم أمام معضلة الانتماء داخل دولة حديثة التشكّل، لكن خصوصيتهم تمثّلت في كونهم جماعة ذات امتداد عابر للحدود، وهو ما جعل حضورهم موضع ريبة دائمة في نظر السلطات. تعاملت الإدارة الفرنسية مع هذا الواقع ببراغماتية واضحة: فمن جهة، سمحت بهوامش ثقافية وتنظيمية محدودة، وشجّعت أحياناً على إبراز الخصوصيات المحلية، ومن جهة أخرى، امتنعت عن تحويل هذا التنوع إلى أساس قانوني أو سياسي لبناء دولة تعددية.
لم يكن هدف الانتداب الاعتراف بالهويات المختلفة أو دمجها في عقد وطني جامع، بل استخدام التنوّع أداة لإدارة المجتمع وضبطه، ومنع تشكّل مركز سياسي موحّد قد يهدّد السيطرة الاستعمارية. هكذا، جرى التعامل مع الأكراد، كما مع غيرهم من المكوّنات، بوصفهم ورقة توازن أكثر منهم شركاء في مشروع سياسي مشترك.
ومع انتهاء مرحلة الانتداب، ورثت الدولة السورية الناشئة هذا الإرث الثقيل: دولة بحدود واضحة، وهوية رسمية واحدة، ومجتمعات متعدّدة لم يُحسم موقعها السياسي بعد. عند هذه النقطة تحديداً، لم تعد المسألة الكردية مجرد سؤال إداري أو ثقافي، بل تحوّلت إلى قضية مؤجَّلة، سترافق سوريا الحديثة منذ ولادتها.
الاستقلال
مع نيل سوريا استقلالها عام 1946، دخل الأكراد مرحلة أكثر تعقيداً وحساسية. فالدولة السورية الناشئة، الساعية إلى ترسيخ شرعيتها وبناء هوية وطنية جامعة، اختارت القومية العربية إطاراً ناظماً وحيداً للانتماء، وقدّمته بوصفه أساس الوحدة السياسية والثقافية للدولة الجديدة. ضمن هذا التصوّر، جرى التعامل مع أي تعبير قومي آخر لا باعتباره تنوّعاً مشروعاً، بل تهديداً محتملاً لوحدة البلاد.
لم يكن هذا الخيار مجرّد موقف نظري، بل تُرجم سريعاً إلى سياسات وممارسات متراكمة، لم تتّسم دائماً بالعنف المباشر، لكنها اتسمت بالثبات والانتظام. أُقصيت الهوية الكردية من الفضاء العام، وحُوصرت لغتها وثقافتها، ومُنع تشكّل تمثيل سياسي مستقل يعكس خصوصيتها أو يعبّر عن مطالبها داخل مؤسسات الدولة.
اعتمدت السلطة، في تلك المرحلة، أسلوب التذويب بدل المواجهة المفتوحة: الإقرار بوجود اجتماعي غير معلَن، مقابل إنكار سياسي وقانوني شبه كامل. وبذلك، لم يدخل الأكراد في صدام شامل مع الدولة، لكنهم أُقصوا تدريجياً عن تعريفها الرسمي للمواطنة والانتماء.
هكذا، ومع صعود القومية العربية كهوية مهيمنة، تحوّل الوجود الكردي من مكوّن تاريخي في المجتمع السوري إلى مسألة حسّاسة تُدار بالحذر والإنكار. هذا المسار، الذي بدأ في سنوات الاستقلال الأولى، سيشكّل الأرضية التي بُنيت عليها سياسات لاحقة أكثر حدّة، ويضع الأساس لعلاقة ملتبسة بين الأكراد والدولة، ستستمر آثارها لعقود طويلة.
لحظة التحوّل الصامت
في محافظة الحسكة عام 1962، أُجري ما عُرف بـ”الإحصاء الاستثنائي”، وهو إجراء إداري بدا، في ظاهره، تقنياً ومحدوداً، لكنه شكّل في جوهره واحدة من أكثر المحطات تأثيراً في علاقة الدولة السورية بالمجتمع الكردي. بموجب هذا الإحصاء، جُرّد عشرات الآلاف من الأكراد من جنسيتهم السورية، تحت ذرائع مثل “التسلّل” أو “عدم الأهلية”، من دون مسارات قانونية واضحة، أو ضمانات للاعتراض والمراجعة.
لم يكن الإحصاء حادثاً معزولاً أو خطأً بيروقراطياً عابراً، بل لحظة تأسيسية أعادت تعريف موقع الأكراد داخل الدولة. فجأة، تحوّل مواطنون إلى فئة قانونية معلّقة: مواطنون بلا حقوق، مقيمون بلا اعتراف، وحياة يومية تُدار بوثائق ناقصة، ووجود قانوني هشّ يطال التعليم والعمل والتملّك وحتى حرية التنقّل.
ما ميّز هذه السياسة أنها لم تُترجم فقط إلى أرقام وسجلات، بل إلى آثار اجتماعية عميقة امتدّت عبر الأجيال. فقد أنتج الإحصاء واقعاً من التهميش البنيوي، ورسّخ شعوراً دائماً بعدم الأمان القانوني، وأعاد رسم العلاقة بين الفرد والدولة على أساس الشك والإنكار.
وبالرغم من توثيق هذه الانتهاكات لاحقاً من قبل منظمات حقوقية دولية وباحثين مستقلين، ورغم صدور قرارات جزئية لمعالجة آثارها بعد عقود، لم يُلغَ الإحصاء فعلياً بوصفه سياسةً إلا شكلياً. بقيت نتائجه حاضرة في البنية الاجتماعية والسياسية للمناطق الكردية، وظهرت تداعياته بوضوح حتى ما بعد عام 2011، حين خرج المؤجَّل إلى العلن، وعاد سؤال المواطنة ليطرح نفسه من جديد.
طريق مسدود
حتى أواخر ستينيات القرن الماضي، لم يشهد الملف الكردي في سوريا انفجاراً سياسياً واسعاً أو مواجهة مفتوحة مع الدولة، لكنه كان يتخمّر بصمت، في ظل انسداد شبه كامل للأفق السياسي. فالأحزاب الكردية، التي بدأت بالظهور منذ الخمسينيات في سياق إقليمي مضطرب، ظلّت محدودة التنظيم والتأثير، وملاحقة أمنياً، وعاجزة عن العمل العلني أو بناء قواعد اجتماعية واسعة. في المقابل، كان المجال السياسي السوري برمّته يعيش حالة انغلاق متزايد، لا تتيح لأي تعبير منظّم خارج الإطار الرسمي أن يرى النور.
في تلك المرحلة، كانت الدولة السورية ماضية في تثبيت نموذج قومي أحادي، يرى في القومية العربية الإطار الوحيد للهوية والانتماء، ولا يترك هامشاً فعلياً للتعدّدية السياسية أو الثقافية. ضمن هذا التصوّر، جرى التعامل مع المطالب الكردية لا بوصفها حقوقاً سياسية قابلة للنقاش، بل كإشكال أمني يمكن احتواؤه وإدارته. لم تُطرح حلول بنيوية، ولم يُفتح نقاش جدي حول المواطنة المتساوية أو الاعتراف بالتنوّع، بل ساد منطق التأجيل والإنكار.
أدّى هذا المسار إلى غياب قيادة كردية قادرة على تحويل التململ الاجتماعي المتراكم إلى مشروع سياسي واضح المعالم. فبين القمع الأمني من جهة، وضعف البنية التنظيمية من جهة أخرى، بقي الفعل السياسي الكردي محصوراً في دوائر ضيّقة، عاجزاً عن الوصول إلى المجال العام أو التأثير في موازين القوة.
كان السؤال الكردي، في جوهره، حاضراً بقوة: سؤال الهوية، والمواطنة، والحقوق، والانتماء إلى دولة لا تعترف بتعدّدها. لكنه ظل بلا أدوات تعبير مشروعة، وبلا قنوات سياسية تسمح بترجمته إلى مطالب قابلة للتداول أو التفاوض. هكذا، ومع اقتراب عام 1970، بدا الملف الكردي عالقاً في طريق مسدود: لا انفجار يغيّر المعادلة، ولا تسوية تفتح أفقاً جديداً، بل تراكم صامت سينتظر تحوّلاً أكبر في بنية السلطة، وفي موازين القوة، كي يخرج إلى العلن.
يتغيّر الشكل لا الجوهر
مع وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970، دخلت العلاقة بين الدولة السورية والأكراد مرحلة جديدة، لا قطيعة فيها مع ما سبق، بل إعادة تنظيم وضبط. بدا المشهد، للوهلة الأولى، أكثر استقراراً وأقل فوضى، لكن هذا الاستقرار لم يكن نتاج تسوية سياسية أو اعتراف بالحقوق، بل نتيجة إحكام القبضة الأمنية وإعادة ترتيب آليات السيطرة.
لم يُطرح السؤال الكردي بوصفه قضية وطنية تحتاج إلى حل، ولم يُفتح نقاش حول المواطنة أو التعدّدية، بل جرى احتواؤه ضمن منطق الإدارة الأمنية الصارمة. أُغلقت مسارات العمل السياسي، وضُبط المجال العام، وتحوّلت المسألة الكردية إلى ملف يُدار بهدوء، ويُرحَّل من مرحلة إلى أخرى من دون معالجة جذريّة.
في هذا السياق، لم يسعَ النظام الجديد إلى تفجير الصراع، لكنه لم يسعَ أيضاً إلى حلّه. اختار التأجيل المنهجي: تثبيت الاستقرار مقابل تجميد الأسئلة الكبرى. وهكذا، لم تختفِ أسباب التوتّر، بل تراكمت تحت السطح، في مجتمعٍ جرى ضبطه بالقوة، لا إشراكه بالسياسة.
ذلك “الهدوء” الذي ساد لعقود لم يكن نهاية للصراع، بل شكلاً آخر له. فالسؤال الكردي، الذي أُخرج من المجال العام وأُقصي عن السياسة، ظلّ كامناً، ينتظر لحظة انهيار البنية التي كبحت ظهوره. وبعد أكثر من أربعة عقود، ومع تفكك السلطة المركزية، سيعود هذا السؤال بقوة، لا من هامش التاريخ هذه المرّة، بل إلى قلب الصراع السوري نفسه.