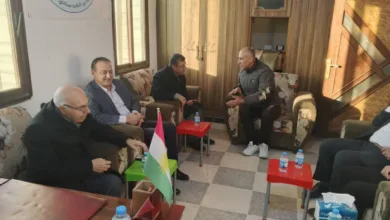ماذا يُخبرنا أثر العنقاء عن اقتصاد سوريا؟

مؤشرات التعافي بعد عامٍ من سقوط نظام الأسد
مسلم عبد طالاس
الجمهورية نت:16/12/2025
مرّ عام كامل على سقوط نظام عائلة الأسد، وهي مناسبة تُحتّم التوقف عندها اقتصاديّاً بقدر ما هي منعطفٌ سياسيٌّ. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتعلق بمدى ما تحقَّق خلال هذا العام، وما إذا كانت المؤشرات الأولية تسمح بالحديث عن بداية تعافٍ اقتصاديٍّ أم عن استمرار حالة الجمود التي رافقت سنوات الصراع.
في الظروف الطبيعية يُقاس الأداء الاقتصادي عبر المؤشرات الكميّة، وعلى رأسها معدل النمو، إلا أن هذا الأخير بطبيعته مؤشر بطيء الظهور ويحتاج إلى ما يشبه فترة حضانة. وتتضاعف صعوبة التقييم عندما تكون البلاد خارجة من نزاع طويل وتُعاني من ندرة شديدة في البيانات، كما هو الحال في سوريا، حيث يُصبح أي حكم مباشر ضرباً من التخمين. لكن غياب الأرقام لا يعني غياب القدرة على التحليل. فالأدبيات الاقتصادية طوّرت أدوات تُساعد على قراءة ما يجري عندما تنعدم البيانات الرسمية، من أبرزها مفهوم «أثر العنقاء» الذي يتتبع كيفية نهوض الاقتصادات من تحت الرماد بعد الحروب الكبرى.
يرجع ظهور هذا المفهوم إلى ملاحظات أورجانسكي وكوجلر في السبعينيات حين لاحظا أن دولاً خرجت من صراعات كبرى سجّلت نمواً مرتفعاً عقب توقف العمليات العسكرية، نمواً يفوق في بعض الأحيان ما تُحققه الدول المُستقرة. وقد واصل كولير وهوفلر إثراء هذا النقاش بتأكيد أن السنوات الأولى للسلام غالباً ما تَتَّسم بطفرة نمو استثنائية، بينما أشار مانكور أولسون إلى أن الحروب، رغم كلفتها، قد تُزيح أحياناً عوائقَ مؤسسية متصلبة وتشابكات مصالح كانت تكبح النشاط الاقتصادي. ما يجمع بين هذه المقاربات هو أنّ الارتداد الاقتصادي الأولي لا يتطلب إصلاحات جذرية أو تدفقات استثمارية ضخمة، بل يكفي في العادة تحسّن الحد الأدنى من الأمن كي تعود الأصول الإنتاجية العاطلة إلى العمل. هذا ما يُطلق عليه النمو الاسترجاعي، وهو عملية استعادة النشاط الطبيعي الذي كان معطلاً بفعل الاقتتال، حيث تعود المصانع للإنتاج لمجرد فتح الطرق وتأمين الوقود، ويستأنف المزارعون العمل بمجرد تراجع المخاطر، وتستعيد شبكات النقل والكهرباء جزءاً من فاعليتها دون أن تدخل أموال جديدة إلى السوق. لذلك حققت دول مثل رواندا والبوسنة معدلات نمو تجاوزت 30 بالمئة في السنوات الأولى للسلام، وهو الحد الأدنى المُتوقع عندما تستقر الأوضاع ويتحرر الاقتصاد من الخوف.
وعند النظر إلى سوريا بعد عام واحد من التغيير السياسي، لا نجد أثراً لهذا الارتداد الطبيعي. فالبنك الدولي يتوقّع نمواً للاقتصاد السوري لا يتجاوز 1 بالمئة في عام 2025، وهو رقم لا يعكس فقط ضعفاً اقتصادياً، بل يُشير بوضوح إلى غياب الديناميكية الأساسية التي يُفتَرض أن تنطلق تلقائياً بعد الحرب. الفجوة بين هذا الرقم ومعدلات تتراوح بين 25–40 بالمئة شهدتها اقتصادات خرجت من صراعات مشابهة ليست فارقاً تقنياً، بل علامة على أن الأصول العاطلة لم تعد للعمل وأن شروط التعافي الأولى لا تزال غائبة. فلو توافر حد أدنى من الاستقرار الأمني، لكانت عجلة الإنتاج قد دارت ولو جزئياً، ولشهدنا نمواً يتجاوز 5–10 بالمئة على الأقل، وهو المستوى الذي ينشأ من عودة النشاط المُعلّق أكثر مما ينتج عن أي سياسة حكومية. إن غياب هذا الارتداد يعني أن الاقتصاد السوري ما يزال فعلياً في حالة ما قبل التعافي، أي في وضع لا يختلف كثيراً عن سنوات الحرب نفسها.
لا تكمن المعضلة هنا في تأخر السياسات الاقتصادية أو ضعف الاستثمارات، بل في غياب البيئة الأولية التي تسمح للنشاط الاقتصادي بأن يلتقط أنفاسه. فالمشهد الأمني، رغم انحسار القتال الرسمي، لم يصل إلى حالة تسمح بحرية حركة البضائع والعمالة. إذ ما تزال مناطق واسعة خارج السيطرة الكاملة للدولة، والسلطات الفعلية على الأرض متعددة، مما يجعل النشاط الاقتصادي محفوفاً بالكلفة والمخاطر. وفي خلفية هذا كلّه يعمل اقتصاد حرب لم يتفكك بعد؛ منظومة قائمة على المعابر الخارجة عن السيطرة الرسمية، والرسوم غير القانونية، وشبكات التهريب، والجهات المسلحة التي تستفيد من استمرار الهشاشة. في مثل هذه البيئة تُصبح كلفة العمل في الاقتصاد النظامي أعلى من كلفة العمل في السوق الموازية، فيتردد المنتجون في العودة إلى قنوات الإنتاج الشرعية.
يزداد المشهد تعقيداً مع صعود بنية موازية للسلطة الاقتصادية حملت معها نموذجاً إدارياً ريعياً كان قد تطور في إدلب، ثم تمدد بسرعة في اقتصاد هشٍ يُعاني أصلاً من ضعف الدولة. ما حدث ليس تفكيكاً لاقتصاد الحرب القديم، ولا بناء لمؤسسات دولة حديثة، بل إنتاج خليط جديد يجمع بين شبكات الفساد التي نشأت في إدلب وتلك الموروثة عن نظام الأسد، لتتشابك مصالح الطرفين في التحكم بالأسواق والموارد. ومع هذا التشابك أصبحت تكلفة تشغيل الأصول الإنتاجية أعلى من عوائدها، وفقد الاقتصاد النظامي قدرته على منافسة أنماط الجباية الموازية، مما جعل العودة الطبيعية للإنتاج شبه مستحيلة. وهكذا لم تعد الدولة تحتكر السلطة الاقتصادية أو تُحدد قواعد موحدة للسوق، بينما تستمر البنية الموازية في إعادة تدوير اقتصاد الحرب بصيغة جديدة.
تصف بعض الأدبيات الاقتصادية السنة الأولى لما بعد انتهاء النزاع بالنافذة الذهبية للتعافي، وهي الفترة التي تمتاز بوجود رغبة عامة في إعادة البناء، وبضعفِ شبكات المصالح القديمة، وباستعدادِ المستثمرين للنظر إلى البلد باعتباره على أعتاب تحوّل مؤسسيٍّ. ضياعُ هذه السنة من دون أيِّ تحسن ملموس لا يُمثل إخفاقاً ظرفياً، بل خسارةً لفرصة نادرة لا تُعوض بسهولة. فكل شهر إضافي يَمرُّ في بيئة غير مستقرة يُعمّق جذورَ اقتصاد الحرب، ويُقلل من قدرة الدولة على فرض قواعد جديدة، ويزيد كلفة الإصلاح إلى درجة قد تجعل عودة الاستثمار الخارجي أشبه بالمستحيل.
عندما نقرأ المشهد السوري عبر عدسة «أثر العنقاء»، تَتضح لنا صورة اقتصاد لم يدخل بعد مرحلة التعافي. معدلات النمو شبه معدومة، الأصول الإنتاجية العاطلة ما تزال خارج دورة العمل، فيما يلتهم اقتصاد الحرب والفساد الحصة الأكبر من الحوافز، والدولة ليست في موقع يسمح لها بإعادة بناء مؤسسات السوق، يكاد المناخ الاستثماري يكون غائباً، وحركة الإنتاج لم تستعد إيقاعها الطبيعي. هذا ليس اقتصاداً ينهض من رماده، بل اقتصاد مُعلق في منطقة رمادية لا تنتمي إلى الحرب ولا إلى السلام، مهما روّج في الخطاب الرسمي عن تدفقات مالية قادمة. فالعبرة في نهاية المطاف لا تكمن في الوعود، بل في عودة دورة الإنتاج إلى الحياة.