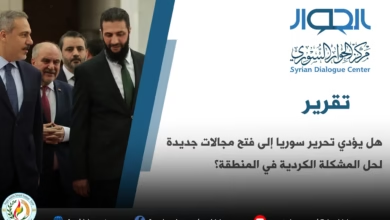مسودة البرنامج السياسي

(للمناقشة)
حركة البناء الديموقراطي الكردستاني –سوريا
مقدمة:
منذ انبثاق وتبلور الحركة السياسية الكوردية في سوريا بشكلها المنظّم في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي. مرّت بالعديد من المراحل، وواجهت العديد من التحدّيات، واستطاعت ان تتجاوز بعضها لكنها فشلت أمام أخرى.
وإذا كان للعوامل الموضوعية دورٌ كبير في ضعف هذه الحركة وتشتتها وترهّل أدائها، فإن العامل الذاتيّ قد لعب الدور المفصلي في مساعدة العوامل الموضوعية وضرب الحركة في الصميم. لذا لا يمكننا تبرئة القيّمين على الحركة السياسية الكوردية من فتح المجال للآخرين سواء من الداخل أو من الخارج لجعلها رهن التبعية وفاقدة للقرار السياسي الكوردي السوري المستقل.
وقد كشفت الأحداث والمتغيّرات المفصلية التي شهدتها الساحة السورية على مدى عقدين من الزمن على عدم قدرة الحركة الكوردية على مواكبة الأحداث وقيادة المشهد السياسي ناهيك عن غياب دور المبادرة الاستباقية، لهذا كان لا بد من العمل على إيجاد بديل نضالي ديمقراطي يعبّر بشكل حقيقي ومتوازن عن القضية الكوردية في سوريا بعيداً عن التبعية لأي طرف كان، والإصرار على رفض تقزيم هذه القضية أو حصرها في حيّز ضيّق، لذا التأمَتْ إرادتنا وتوجّهت نحو تأسيس حالة سياسية – تنظيمية كوردية، من مستلزماتها توفير السبل الكفيلة بِسَدّ الفراغ القائم وانجاز التمثيل السياسي الصحيح والمناسب، لردّ الاعتبار للشعب الكوردي وقضيته القومية في سوريا. وتكلل العمل على تجسيد هذه الحالة ببناء تنظيم سياسي جديد ليصيغ مشروعاً سياسيّاً يعبّر عن واقع المرحلة الراهنة ويجمع الإمكانيات التنظيمية الهائلة والطاقات الجماهيرية الواسعة لبناء حامل قويّ للمشروع المنشود، مفسحاً المجال امام الطاقات النضالية الكامنة في مجمل مناطق التواجد الكردي في سوريا والشتات.
عرض تاريخي
يعيش الكُرد في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من سوريا، وذلك على طول حدودها مع كلٍّ من تركيا والعراق، وذلك بالقرب من شواطئ المتوسط غرباً وحتى الحدود العراقية شرقاً وبعمق غير متجانس يصل الى ما يزيد عن 100 كم في بعض المواقع، بشكلٍ موازٍ لمناطق تواجد الكُرد في تركيا والعراق، على طول الحدود في المحافظات التالية: (الحسكة – الرقة – حلب – إدلب – حماة – اللاذقية )، إلى جانب حضورهم الكثيف في أغلب المدن السورية سيما الكبرى منها، مثل دمشق، وحلب، واللاذقية، وحمص. وقد تشكلت حدود سوريا مع تركيا بين عامي 1920 – 1939، ومع العراق بين عامي 1920 – 1923، وذلك على إثر خسارة الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الاولى (1914 – 1918) وانهيارها لاحقاً.
الواقع السياسي لكُردستان قبل الحرب العالمية الأولى
تعود جذور المشكُلة الكردية إلى ما قبل الميلاد بفترة طويلة وإن لم تكن تعرف بهذا الوصف، حيث تسبب سقوط الإمبراطورية الميدية (678 – 549 ق .م) على يد الفرس الأخمينيين، وتعرضهم لاستعباد الأقوام الهندو – أوروبية التي نزحت إلى منطقة كُردستان الحالية، في ظهور شعور مبكر بالظلم الى جانب اغتصاب الهوية، حيث لم يتخذ ذلك مظاهر قومية في حينها لكنه أسس للمشكلة التي مرت عليها فترات هدوء بعد السيطرة الإسلامية التي أقام الكُرد في مراحل منها إمارات عديدة تحكم نفسها في إطار الدولة الإسلامية، وذلك قبل أن تبدأ المعالم الحديثة للمشكلة الكردية بالتشكل مع بدايات القرن السادس عشر.
بدأت المشكلة الكردية بصورة واضحة في العصر الحديث عند اصطدام القوتين الصفوية والعثمانية عام (1514م) في معركة جالديران، وكان من نتائجها تقسيم كردستان عملياً بينهما.
كانت كُردستان قبل سنة (1514م) تدار على شكل إمارات مستقلة تقوم بتنظيم شؤونها الداخلية، لكن سوء معاملة الشاه إسماعيل الصفوي، إضافةً إلى الاختلاف المذهبي أدى إلى وقوف أكثرية الإمارات الكُردية إلى جانب السلطنة العثمانية فضلاً عن جهود رجل الدين الملاّ إدريس البدليسي (1452 – 1520م) الذي لعب دوراً كبيراً في استمالة الكُرد إلى جانب العثمانيين، وجاءت نتائج المعركة المذكورة وتداعياتها اللاحقة لتلحق الجزء الأكبر من جغرافية كردستان بالسلطنة العثمانية. وفي عام 1515 قام الملاّ إدريس البدليسي، بتفويض من السلطان العثماني، بعقد اتفاق مع الأمراء الكُرد، يتضمن اعتراف السلطنة العثمانية بسيادة تلك الإمارات على كُردستان وبقاء الحكم الوراثي فيها، ومساندة الأستانة لها عند تعرضها للغزو أو الاعتداء مقابل أن تدفع الإمارات الكُردية رسومات سنوية كرمز لتبعيتها للسلطنة العثمانية وأن تشارك إلى جانب الجيش العثماني في أية معارك يخوضها. إضافة إلى ذكر اسم السلطان والدعاء له من على المنابر في خطب الجمعة. وتضمن هذا الاتفاق اعترافا من السلطنة العثمانية بالسلطات الذاتية للأمراء الكُرد على إماراتهم.
وفي عام (1555م) عقد الجانبان الصفوي والعثماني أول اتفاق ثنائي بينهما عُرف بـمعاهدة “أماسيا”، وهي أول معاهدة رسمية بين الجهتين. وتم بموجبها تكريس تقسيم كردستان رسمياً وفق وثيقة رسمية نصت على تعيين الحدود بين الجانبين، وخاصة في مناطق شهرزور، وقارص، وبايزيد (وهي مناطق كُردية صرفه). وتلت تلك المعاهدة، معاهدات واتفاقيات لاحقة منها: معاهدة “زهاو” أو تنظيم الحدود عام (1639م) بين الشاه عباس والسلطان مراد الرابع، وتم التأكيد فيها على معاهدة أماسيا بالنسبة لتعيين الحدود، زاد هذا من تعميق المشكلة الكُردية. ثم عقدت بعد ذلك معاهدات أخرى مثل معاهدة “أرضروم الأولى” (1823م) و “أرضروم الثانية” (1847م) واتفاقية طهران (1911م) واتفاقية تخطيط الحدود بين الجانبين عام (1913م) في الأستانة، وكذلك بروتوكول الأستانة في العام نفسه. وقد كرست جميع تلك المعاهدات تقسيم كُردستان وشعبها بشكل مجحف، وبسبب ذلك تعقدت المشكلة الكُردية يوماً بعد آخر، ولا سيما بعد بدء انتشار الأفكار القومية في الشرق، وبالأخص منذ بداية القرن التاسع عشر، حيث بدأت الدول الأوروبية تحتك بكردستان عن طريق الرحالة الأجانب والإرساليات التبشيرية، وكذلك عن طريق بعض القنصليات وأهمها البريطانية والروسية والفرنسية ثم الأميركية. ومارست كل هذه الجهات أدواراً مهمةً في تحريض العشائر الكُردية ضد السلطنة العثمانية خاصةً، ثم الشاهنشاهية الصفوية، للحصول على بعض الامتيازات، أو الحصول على المزيد من النفوذ في السلطنة العثمانية خاصةً. وبالرغم من هذا، فإن الجانبين العثماني والصفوي، لم يتمكنا من بسط سيطرتهما على كُردستان لأسباب عدة، منها طبوغرافية كُردستان المعقدة، ودفاع الكُرد عن أرضهم ببسالة.
بداية تدويل القضية الكردية
لقد أدّى اشتداد الصراع الدولي على الشرق، وخاصة بين القوتين البريطانية والروسية إلى خروج المشكلة الكُردية من الطابع الإقليمي إلى الطابع الدولي، كما يتضح من خلال النقاط الآتية:
أولاً: الاتصال المبكر بالكُرد من قبل روسيا، ثم بريطانيا، حيث كانت الحكومة الروسية شديدة الاهتمام بأوضاع البلدان والشعوب المتاخمة لحدودها، ونظرت الحكومة البريطانية بقلق بالغ إلى الأطماع الروسية خوفاً من أن يمتد الروس إلى بلاد ما بين النهرين. وكانت شركة الهند الشرقية(كانت شركة الهند الشرقية التي تأسست عام 1600م هي الوسيلة التي نفذت بها بريطانيا سياساتها الإمبريالية في آسيا، وحققت الملايين من خلال تجارتها العالمية في التوابل والشاي والمنسوجات والأفيون. وقد تعرضت لانتقادات بسبب احتكاراتها، وشروطها التجارية القاسية، وفسادها، والضرر الذي ألحقته بتجارة الصوف. وأخيراً وليس آخراً، جرفت شركة الهند الشرقية الحكام الذين وقفوا في طريقها، واختلست الموارد بلا هوادة، وقمعت الممارسات الثقافية للشعوب التي تعيش داخل أراضيها الشاسعة. باختصار، كانت شركة الهند الشرقية “رأس الحربة الحادة للإمبراطورية البريطانية” اكتسب مدراء شركة الهند الشرقية ومساهموها ثروات هائلة. وعلى النقيض من ذلك، أصبحت الهند أكثر فقراً من أي وقت مضى. شركة الهند الشرقية أكبر بكثير من مجرد شركة تجارية، وأصبحت الشركة في نهاية المطاف دولة داخل دولة، وحتى إمبراطورية داخل إمبراطورية، وواحدة لا تخضع للمساءلة أمام أحد باستثناء مساهميها.) التي تأسست عام 1600م هي الوسيلة التي نفذت بها بريطانيا سياساتها في آسيا، وحققت أرباحاً طائلة من خلال تجارتها العالمية في التوابل والشاي والمنسوجات والأفيون. وقد تعرضت لانتقادات بسبب احتكاراتها، وشروطها التجارية القاسية، وفسادها، والضرر الذي ألحقته بتجارة الصوف. وأخيراً وليس آخراً، جرفت شركة الهند الشرقية الحكام الذين وقفوا في طريقها، واختلست الموارد بلا هوادة، وقمعت الممارسات الثقافية للشعوب التي تعيش داخل أراضيها الشاسعة ونهبت ثروات تلك شعوب وتحولت إلى إمبراطورية داخل إمبراطورية ولا تخضع للمساءلة أمام أحد باستثناء مساهميها، وواحدة من أهم بؤر التجسس في المنطقة، كما كانت هنالك محاولات فرنسية للتغلغل في كُردستان عن طريق الإرساليات التبشيرية. ويمكن القول أن أمريكا كانت موجودة في المنطقة على عكس ما كان شائعاً من تطبيقها لمبدأ “مونرو” الذي يؤكد على عدم التورط في المشاكل السياسية خارج حدود أمريكا. ثانياً: محاولات الكُرد أنفسهم للقاء البريطانيين في بداية القرن العشرين، حيث كانت جهود الدبلوماسي الكردي شريف باشا واضحة في هذا المجال، إذ حاول الاتصال بالإنجليز عام (1914) لكي يشرح لهم طبيعة قضية شعبه، لكن الحكومة البريطانية لم تستجب له، وبحلول عام (1918) وعند احتلال بريطانيا للعراق طلبت وزارة الخارجية البريطانية من السفير بيرسي كوكس ( بيرسي كوكس (بالإنجليزية: Percy Cox) ( 1864- 1937) سياسي بريطاني كان المستشار السياسي لحملة الإنكليز العسكرية لاحتلال العراق، ساهم في رسم السياسة البريطانية في الوطن العربي بعد انهيار الدولة العثمانية، حيث شارك قوات الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين في محاربة قوات الدولة العثمانية.) أن يلتقي بشريف باشا في مدينة مرسيليا الفرنسية للاستماع إلى أقواله فقط!
ثالثاً: اتفاقية سايكس – بيكو عام (1916) حيث اجتمع وزراء خارجية كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا، ودارت بينهم مباحثات سرية حول الترتيبات المقبلة للشرق الأوسط، بعد أن أصبحت هزيمة ألمانيا وحليفتها السلطنة العثمانية وشيكة، وتضمنت الاتفاقية تقسيم تركة الأخيرة، وبما أن القسم الأكبر من كُردستان كان تحت السيطرة العثمانية، فقد شملها التقسيم، وهذا الوضع الجديد زاد من تعقيدات القضية الكُردية، وأخرجها من نطاقها الإقليمي إلى النطاق الدولي، وحطمت آمال الكُرد في تحقيق حلمهم المشروع في تقرير المصير.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عادت القضية الكُردية إلى دائرة الاهتمام من جديد، ولعل سبب ذلك هو محاولة إيجاد منطقة عازلة بين أتراك الأناضول والأقوام التي تتكلم اللغة التركية في آسيا الوسطى والقفقاس وبصورة خاصة في أذربيجان. حيث تحرك الكُرد لاستثمار الظروف الدولية الجديدة لنيل حقوقهم المشروعة والاستفادة من مبادئ ويلسون حول حق الشعوب في تقرير المصير، وبذلوا جهوداً مضنية لإيصال صوتهم إلى مؤتمر الصلح في باريس عام (1919) ، ولم يكن للكُرد كيان سياسي مستقل حتى يشارك وفدهم رسمياً في ذلك المؤتمر شأنهم شأن القوميات والشعوب المضطهدة الأخرى، ولذلك قاموا من خلال العشائر والجمعيات السياسية بتخويل شريف باشا لتمثيلهم والمطالبة بحقوقهم.
أصدر الحلفاء بعد استكمال تحضيراتهم للمؤتمر قراراً في شهر يناير/ كانون الثاني 1919 نص على ما يأتي: ” … إن الحلفاء والدول التابعة لهم قد اتفقوا على أن أرمينيا وبلاد الرافدين وكردستان وفلسطين والبلاد العربية يجب انتزاعها بكاملها من الإمبراطورية العثمانية”. وانطلاقاً من هذا القرار قدم الممثل الكردي شريف باشا مذكرتين مع خريطتين لكُردستان إلى المؤتمر، إحداهما بتاريخ (21/3/1919م) والأخرى يوم (21/3/1920). كما طلب من القائمين على شؤون المؤتمر تشكيل لجنة دولية تتولى تخطيط الحدود بموجب مبدأ القوميات* الذي يتلخص في: “تعبير سياسي يعني شعور أكثرية الناس بالانتماء إلى أمة واحدة، لغةً وثقافةً وتقاليد، على نحو ينحصر فيه هذا الشعور بالولاء للأمة والاعتزاز بثقافتها وتاريخها وحقِّها في إقامة دولتها الخاصة. وهو مبدأ معترف به في القانون الدولي”، لتصبح كُردستان المناطق التي تسكن فيها الغالبية الكردية. وإضافة إلى ذلك فقد جاء في المذكرة الأولى “إن تجزئة كردستان لا يخدم السلم في الشرق…”. كما جاء في المذكرة الثانية “إن الترك يتظاهرون علناً بأنهم مع المطالب الكردية، وإنهم متسامحون معهم، لكن الواقع لا يدل على ذلك مطلقاً…” كما طالب شريف باشا رسمياً من رئيس المؤتمر جورج كليمنصو أن يمارس نفوذه مع حكومة الأستانة لمنع اضطهاد الشعب الكردي، وجاء في رسالته إلى رئيس المؤتمر:
” … إنه منذ أن تسلمت جماعة الاتحاد والترقي السلطة فإن جميع الذين يحملون آمال الحرية القومية قد تعرضوا للاضطهاد المستمر. وإنه من الواجب الإنساني في المجلس الأعلى أن يمنع إراقة الدماء مجدداً، وإن السبيل لضمان السلم في كردستان هو التخلي عن مشروع تقسيم هذه البلاد (أي كردستان) … “. ودل كل ذلك على أن المشكلة الكردية تقدمت خطوة كبيرة إلى الأمام في أعقاب الحرب. وما تصريح كليمنصو عندما أعلن على الملأ في مؤتمر الصلح إلا إحدى العلامات حيث قال “إن الحكومة التركية ليست كفؤة وغير قادرة على إدارة الأمم الأخرى، لذلك لا يمكن الوثوق بها ولا يجوز أن تعاد إلى سيطرة الأتراك قومية عانت من مظالم الأتراك واستبدادهم “.
وعندما رأى شريف باشا أن هناك تعاطف كبير من جانب الدول الأوروبية للقضية الأرمنية ربما بسبب الانتماء الديني للأرمن بادر إلى عقد اتفاقية مع ممثل الأرمن بوغوص نوبار وبحضور الرئيس المؤقت لوفد جمهورية أرمينيا أوهانجيان. ووقع الجانبان باسم الشعبين الاتفاقية، مؤكدين فيها على أن للكُرد والأرمن مصالح وأهدافا مشتركة هي: الاستقلال، والتخلص من السيطرة العثمانية. وقدما نص الاتفاقية بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى للمؤتمر، ووافق المجلس مبدئياً على المذكرة، ووصف المندوب السياسي البريطاني في الأستانة الاتفاقية بأنها من أسعد البشائر.
معاهدة سيفر (1920):
نجح شريف باشا في إدخال ثلاثة بنود تتعلق بالقضية الكردية في معاهدة سيفر التي أبرمها الحلفاء بباريس في آب 1920، وقد كرس ذلك عملية تدويل القضية الكردية بصورة رسمية، رغم أن الحكومة التركية حاولت مراراً أن تصف القضية الكُردية بأنها قضية داخلية تستطيع هي حلها. وتعد معاهدة سيفر وثيقة فريدة في تاريخ القضية الكُردية، حيث نصت على إيجاد حل للقضية الكُردية على مراحل، وإذا اجتاز الكُرد هذه المراحل، وطالبوا بالاستقلال، ورأت دول الحلفاء أهلية الكُرد لذلك يصبح الاستقلال أمرا واقعياً، وعلى الحكومة التركية الاعتراف بذلك… ويعد هذا أول اعتراف رسمي دولي بحق الكُرد في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم القومية. وقد وصف كمال أتاتورك المعاهدة بأنها بمثابة حكم بالإعدام على تركيا، وحاول بمختلف الوسائل وضع العراقيل لمنع تطبيقها، ولذلك بقيت معاهدة سيفر حبراً على ورق، إلا أن ما ورد فيها من بنود شكلت أملاً ودافعاً كبيراً لنضال الحركة القومية الكُردية فيما بعد .
أسباب فشل معاهدة سيفر:
أولاً: صعود نجم “مصطفى كمال أتاتورك” في قيادة الحركة الوطنية التركية، وتوسيع مناطق نفوذها، إضافة إلى تأسيس المجلس الوطني الكبير في أنقرة وقطع العلاقة مع الأستانة، لأنها كانت الجهة التي وقعت تلك المعاهدة.
ثانياً: خوف الدول الأوروبية، وبالأخص بريطانيا، من استغلال الشيوعيين في الاتحاد السوفياتي الصراع بين تركيا الكمالية – وأوروبا الغربية لصالح نفوذهم في المنطقة.
ثالثاً: قدرة مصطفى كمال على استغلال الصراع الدولي لإلغاء معاهدة سيفر وقبرها. لذلك لم يمر عام ونصف على توقيع معاهدة سيفر حتى طرحت فكرة إعادة النظر فيها، وجاء هذا المواقف من قبل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتخذ المجلس الأعلى للحلفاء قراراً بهذا الشأن يوم (25 يناير 1921) إضافة إلى توجيه الدعوة إلى وفد حكومة أنقرة لحضور المؤتمر القادم، الأمر الذي دلّ على اعتراف الحلفاء بالواقع الجديد في تركيا.
مؤتمر لندن (1921):
عقد مؤتمر لندن في شباط 1921 لبحث القضايا العالقة، ومن ضمنها القضية الكُردية، حيث اعتزم الحلفاء إعطاء تنازلات مهمة في هذه القضية، لكن الحكومة التركية أصرت على أن المسألة داخلية، يمكن حلّها داخلياً، لا سيما وأن الكُرد لهم الرغبة في العيش مع إخوانهم الأتراك حسب ما زعمها، وأثناء انعقاد مؤتمر لندن، عقدت حكومة أنقرة عدداً من الاتفاقيات الدولية التي كرست الشرعية الدولية القانونية للنظام الجديد في تركيا… ثم قامت الحكومة الجديدة بإلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها حكومة الأستانة ومن ضمنها معاهدة سيفر. كل ذلك أدى إلى تعزيز مكانة الحكومة التركية الجديدة وضربة إضافية للآمال القومية الكُردية.
معاهدة لوزان (1923):
جاءت فكرة عقد معاهدة لوزان بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها الحكومة التركية الجديدة على الجيش اليوناني، وبذلك ظهرت تركيا كدولة فتية قوية لأول مرة، وقامت الحكومة الجديدة بتحسين العلاقة مع جارتها الشيوعية (الاتحاد السوفياتي)، وعقدت مباحثات المعاهدة على فترتين: استمرت الأولى نحو ثلاثة أشهر بين نهاية العام 1922 وبداية العام 1923، والفترة الثانية استمرت الفترة ذاتها ما بين ربيع وصيف عام 1923.ونصت معاهدة لوزان على أن تتعهد أنقرة بمنح سكان تركيا الحماية التامة والكاملة، ومنح الحريات دون تمييز، من غير أن ترد أية إشارة للكُرد فيها، كما لم ترِد أية إشارة إلى معاهدة سيفر، واعتبر الكُرد أن هذه المعاهدة شكلت ضربةٌ قاسية ضد مستقبلهم وحطمت آمالهم… وبذلك يتحمل الحلفاء المسؤولية الأخلاقية الكاملة تجاه الكُرد ولا سيما الحكومة البريطانية التي ألحقت فيما بعد ولاية الموصل – التي يشكل الكُرد الأغلبية المطلقة فيها – بالدولة العراقية. وساهم ذلك في زيادة تعقيدات المشكلة الكُردية بعد أن أصبح الوطن الكُردي مقسماً عمليا وقانونيا بين أربع دول بدل دولتين، لتزداد معاناة الكُرد وليبدأ فصل جديد من فصول علاقتهم بالدول الجديدة طغى عليها التوتر والعنف الذي لم يجد حتى اليوم حلولا سياسية حقيقية عادلة، فيما بدأت الأحزاب والقوى القومية الكُردية تتشكل لكي تقود النضال والكفاح من أجل حق تقرير المصير.
بدايات ترسيم الحدود بين تركيا وسوريا:
ورد في الملحق (1) للاتفاقية التركية – الفرنسية بتاريخ 30 أيار عام 1926التي رسمت الحدود بين الدولة السورية والدولة التركية في ثلاث قطاعات:
1- من البحر الأبيض المتوسط إلى محطة ﭽوبان- بي والمقصود جوبان بيك (الراعي بعد تعريبها) وهي مركز ناحية تابعة لمنطقة الباب شمال حلب.
2- من محطة ﭽوبان- بي إلى نصيبين (مدينة كردية ضمن حدود تركية مقابل مدينة القامشلي)
3 – من نصيبين إلى جزيرة بوطان.
هذا وقد تم بموجب ملحق آخر، بتاريخ 22 حزيران عام 1929 حول ترسيم الحدود التركية – السورية المتضمن في الاتفاقية بين تركية وفرنسا، ترسيم القطاع الثالث من الحدود الممتد بين نصيبين والتقاء فش خابور بدجلة في المثلث الحدودي السوري – التركي – العراقي.
الوجود الكُردي في سوريا:
بعكس ما يذهب إليه غلاة القوميين العرب وادعائهم بأن الحضور الكُردي في سوريا كان طارئاً، فإن الوجود الكردي التاريخي في سوريا لم يعد بحاجة الى المزيد من تقديم الأدلة حيث أن التاريخ يتكفل بهذا الجانب إذ يقودنا الى دورهم البارز في قيادة العديد من الامبراطوريات والممالك والحضارات القديمة في سوريا الكبرى (ضمن حدود الهلال الخصيب) بدءاً من الهوريين الذين أقاموا مملكة ألالاخ في عام 2700 ق.م حيث امتدت سيطرتهم من بحيرة وان شرقاً حتى سهل العمق غرباً وبقيت حتى عام 1900 ق.م، وكذلك الامبراطورية التي بناها الميتانيون عام 1600 ق.م وكانت عاصمتها واشوكاني بالقرب من مدينة سري كانيه / رأس العين الحالية وامتدت حدودها من حران شرقاً حتى جبال الامانوس غرباً و حتى الحدود اللبنانية جنوباً بما فيها حماة وحلب وحتى اربيل وجبال زاغروس شرقاً.
وكانت كُردستان سوريا جزءاً من بعض الإمارات الكُردية في زمن الخلافة الإسلامية، كالإمارة الدوستكية والإمارة المروانية على سبيل المثال، كما شكلت جزءاً هاماً من السلطنة الأيوبية.
وفي العهد العثماني كانت كُردستان سوريا جزءا من بعض الإمارات الكردية كولاية الجزيرة وولاية حلب على سبيل المثال، وقد أدت هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى إلى تقسيم إيالة «كردستان العثمانية» (بحسب التسمية العثمانية الرسمية) ليدخل قسم منها في إنشاء دولة جديدة عام 1920 سميت سوريا.
ومنذ تأسيس الدولة السورية لعب الكُرد السوريون دوراً رئيسياً في تاريخها السياسي والعسكري إلاّ أن هويتهم القومية كانت تتعرض دائماً للطمس، كما كان وجودهم وحقوقهم يتعرضان للإنكار والمحاربة، وما تزال هذه الممارسة متبعة حتى اليوم وذلك بدءاً من الدساتير السورية ومروراً بالقوانين والمراسيم الاستثنائية والتعليمات الوزارية والقرارات والتعاميم الإدارية وليس انتهاء بالسلوك اليومي على الأرض على الصعد السياسية والأمنية والتربوية والثقافية…الخ.
المادة الأولى: اسم الحركة
حركة البناء الديمقراطي الكوردستاني – سوريا
المادة الثانية: تعريف الحركة:
هي منظمة سياسية جماهيرية ذات تطلعات ليبرالية، تتكون من أفراد ينتمون إلى مختلف شرائح الشعب الكوردي في سوريا، تجمعهم أهداف مشتركة، ويناضلون معاً وفق قواعد وضوابط تنظيمية محددة، تعتمد النضال السياسي السلمي سبيلاً لتحقيق أهدافها، وتضمن حق اختلاف الرأي في إطار وحدتها التنظيمية، وتعتمد اللامركزية في إدارة شؤونها، والمشاركة الجماعية في صياغة قراراتها، وتؤمن بحقوق الإنسان وحق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها، وتستفيد من الموروث النضالي التحرري العالمي والكوردستاني وبما يتناسب وينسجم مع واقع وخصوصية الشعب الكوردي في كوردستان سوريا. وتعتبر أن القضية القومية الكوردية في سوريا هي قضية وطنية سورية تخص جميع الوطنيين المؤمنين بالتوافق والعيش الحر المشترك والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وتعمل من أجل تأمين الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكوردي في إطار سوريا اتحادية بنظام ديمقراطي على مسافة واحدة من كافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمذهبية. وتبني علاقاتها على مختلف الصعد الوطنية والقومية والاقليمية والدولية من منطلق المصالح المشتركة وعدم التدخل واحترام الخصوصية واستقلالية القرار.
المادة الثالثة: المحددات السياسية للحركة
إن الحركة إذ ترسم سياساتها وتضع تكتيكاتها وتصيغ برامجها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة السياسية وظروف ومستجدات الوضع الدولي والإقليمي والآفاق المستقبلية فإنها تنطلق من المحددات التالية:
1- تنطلق الحركة من حقيقة أن الوجود الكوردي في سوريا هو وجود تاريخي يسبق تشكل الدولة السورية بقرون عديدة، وان جغرافية كردستان سورية بمجملها كانت تشكل جزء من ولاية كردستان العثمانية والتي خضعت للتقسيم الكولونيالي في سايكس بيكو عام 1916 وبهذا بقي الشعب الكردي وجزء من أرض كردستان داخل الحدود السياسية للدولة السورية، ومن هذا المنطلق تعتبر الحركة أن الكورد في سوريا يشكلون القومية الرئيسية الثانية من الناحية العددية، ومكوناً أصيلاً من مكونات المجتمع السوري إلى جانب المكونات الأخرى، وهم في ذات الوقت جزء من الأمة الكوردية، وأن هذا الوجود ليس طارئاً بل إنهم يعيشون على أرضهم منذ فجر التاريخ، وقد ساهموا مع باقي المكونات في بناء الدولة السورية ودافعوا عنها، وصانوا حدودها وشغلوا رئاستها لفترات عديدة وذلك قبل سيطرة الشوفينية عليها.
2- تعمل الحركة بمقتضى التوازن بين الانتماء القومي والوطني، والتلازم بين مساري النضال ببعديه القومي الكوردي والوطني السوري، وتعتبر أن قضية الشعب الكوردي هي قضية وطنية سورية تخصّ كل الوطنيين المؤمنين بالعيش المشترك، وتسعى مع ممثلي كافة المكونات إلى صياغة مشروع وطني سوري تغييري جامع وشامل لإعادة إنتاج جمهورية سورية اتحادية وإقامة البديل الوطني الديمقراطي الذي يقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمذهبية، وعلى أساس التوافق والشراكة الوطنية المتكافئة والتعايش الحر، والإقرار الواضح والصريح في الدستور بوجود الشعب الكوردي وحقوقه القومية المشروعة وكذلك وجود وحقوق كافة مكونات الشعب السوري وفق المواثيق والأعراف الدولية.
3- يرتكز موقف الحركة من أي حدث أو واقعة أو حالة على قاعدة أساسية وهي المصلحة العليا لشعبنا في كردستان سوريا، وتلك المصلحة هي البوصلة في أي تحرك أو موقف أو علاقة أو تحالف، وتعتمدها الحركة كأساس في بناء علاقاتها وتحالفاتها مع القوى والأطراف الأخرى دون الخضوع لأية جهة كانت، مع الأخذ بعين الاعتبار مقوّمات بناء العلاقات والاتفاقات أو التوافقات التي تضمن مصالح جميع أطرافها.
4- ترى الحركة أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الحكم يجب أن يقام على مبدأ التداول السلمي للسلطة وعبر صناديق الانتخاب وضوابط الديمقراطية التوافقية.
5- تؤمن الحركة بمبدأ مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وفصل الدين عن الدولة، وحيادية الدولة تجاه الأديان، والمساواة التامة بين الرجل والمرأة في القانون وفي تطبيقه.
6- تؤمن الحركة بالديمقراطية فكراً وسلوكاً وتمارسها على الصعيد الداخلي بين الأعضاء والهيئات وكذلك على صعيد العلاقة بالجماهير.
7- تضمن الحركة التباينات السياسية داخلها كقوة محركة وبناءة، على أن يتم التعبير عنها وممارستها ضمن الضوابط التنظيمية وانطلاقاً من الإيمان بالديمقراطية وقبول الآخر واحترام رأيه.
8- ترفض الحركة عقلية الاستبداد بالرأي ونفي الآخر والسلوك الإقصائي تجاه المختلف ووحدانية التمثيل، بل ترى في الاختلاف غنىً، وفي التشارك قوة، وتسعى لتنظيم التناقضات المختلفة ومنحها فرصة طرح نفسها كعنصر فاعل في عملية البناء وليس عامل استنزاف، لأن الحرية هي بالأساس نتاج التفاعل الحر بين المختلفين في مناخات الديمقراطية.
9- تعتمد الحركة مبدأ الشفافية والعلنية في عملها وعلاقاتها السياسية، وترفض الفساد وتكافحه بكافة أشكاله.
10- تؤمن الحركة بالفكر المؤسساتي والعمل التخصصي، وذلك في جميع المجالات.
المادة الرابعة: مهام الحركة:
أولاً – على الصعيد الوطني السوري:
• رؤية عامة
1- تستند الحركة في تعاطيها مع القضايا الوطنية العامة بما في ذلك شكل العلاقة مع الأطراف والكيانات السياسية الوطنية والكردية على قاعدة أساسية وهي مصلحة الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي في سوريا بصورة خاصة بحيث لا تتعارض مع وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها ومتطلبات وشروط التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
2- تعتبر الحركة أن قاعدة بناء العلاقات السياسية مع الكيانات السورية الموجودة إنما هو مصلحة وطنية سورية وتخدم في نهاية المطاف القضية العامة للشعب السوري بما في ذلك حقوق الأفراد والجماعات والكيانات.
3- تعتبر الحركة نفسها جزءاً من المعارضة الوطنية السورية التي ترفض العنف والإرهاب وتعتمد النضال السياسي السلمي بمختلف أشكاله سبيلاً للتخلص من الاستبداد وإعادة إنتاج جمهورية سورية اتحادية ونظام ديمقراطي يقف على مسافة واحدة من مختلف مكونات الشعب السوري، وتنطلق من أسس الاخوة والشراكة بين مختلف مكونات الشعب السوري، وتعتبر أن الهوية الوطنية للدولة السورية هي خلاصة مجموع الهويات الفرعية لمكونات الشعب السوري المختلفة، وترفض الكراهية والخطاب العنصري والطائفي، وتسعى لنشر المحبة وقيم العيش المشترك بين أبناء الشعب السوري.
4- ترى الحركة أن الأزمة في سوريا هي ازمة سياسية وحلها يجب أن يكون حلا سياسيا من خلال عملية سورية – سورية برعاية أممية وترفض التغيير الديمغرافي على كامل مساحة سوريا، وترى في تطبيق القرارات الدولية سبيلاً لإنهاء المأساة.
5- ترفض الحركة جعل سوريا منطلقاً لتهديد الدول المجاورة، وتدعم إقامة أفضل العلاقات مع كافة الدول، واتباع الحوار واللجوء إلى الهيئات الدولية المختصة وسيلة وحيدة لحل الخلافات
- المهام المرحلية:
لقد دخلت سوريا مرحلة جديدة منذ اندلاع انتفاضة آذار 2011 التي واجهها النظام بجميع صنوف الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، وارتكب جرائم فظيعة صنفت بكونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومارس النظام جميع الوسائل لقمع الاحتجاجات، ثم جاء التدخل الإقليمي والدولي فكانت النتيجة حرباً بين السوريين والذي نتج عنها تقسيم الجغرافية السورية الى عدة مناطق نفوذ يجري فيها مختلف صنوف الانتهاكات بما في ذلك انتهاك حقوق الإنسان الى جانب الفاقة والحرمان من أبسط سبل العيش الكريم.
ومن هذا الواقع تضع الحركة نصب أعينها المهام التالية:
1- العمل على محاربة الاستبداد ومكافحة القوى المتطرفة والمنظمات الإرهابية وإنهاء نفوذها في جميع أرجاء البلاد.
2- العمل على تأمين الحماية الدولية للمدنيين في اسرع وقت، وإيجاد آليات دولية لتحقيقها وتنفيذها عبر المؤسسات الأممية.
3- العمل بكافة السبل الممكنة لمواجهة الظلم وأدواته، وتقديم العون وتأمين الدعم اللازمين للمناطق المنكوبة.
4- العمل بجدية مع تيارات المعارضة الأخرى من أجل إيجاد البديل السياسي الديمقراطي.
5- العمل على تفكيك الأجهزة القمعية، وإعادة هيكلتها وتحرير مؤسسات الدولة من سطوتها.
6- التواصل والحوار مع جميع المكونات في المجتمع السوري بما يساهم في تعزيز التعايش السلمي والشراكة والتوافق الوطني.
7- توفير شروط بناء الدولة الاتحادية، والإقرار بمبدأ حق تقرير المصير للمكونات القومية ضمن جغرافية سوريا.
8- إقرار اللغة الكوردية كلغة رسمية في البلاد الى جانب اللغة العربية، وتثبيتها في المناهج الدراسية في كافة مراحل التربية والتعليم.
9- الاقرار بتنوع الثقافات في سوريا، والاهتمام بالموروث الثقافي للشعب الكوردي في سوريا والاعتراف برموزه الوطنية واعتبار عيد النيروز عيداً وطنياً.
10- إعادة النظر في التقسيمات الإدارية، وتوزيع المحافظات على عدة أقاليم بالاعتماد على ثنائية الجغرافيا والتركيبة السكانية.
11- تحقيق العدالة الاجتماعية وفق مبدأ تكافؤ الفرص وتبني معايير علمية لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
12- دعم منظمات المجتمع المدني وضمان حرية عملها المستقل.
13- دعم الشباب وضمان تنشئتهم وتعليمهم وتوفير فرص العمل لهم.
14- تحرير الاقتصاد والانفتاح على الأسواق العالمية، ودعم القطاع المشترك، وتوفير المناخ الاستثماري المشجع والجاذب وتشجيع مختلف أشكال الاستثمار للوصول إلى شكل مناسب من النمو والاستقرار الاقتصادي.
15- تعزيز البنية الأساسية وتوفير مقومات الاستدامة والتطور في جميع القطاعات.
16- العمل مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة لتحقيق العملية الانتقالية وتطبيع الوضع في سوريا في أقرب وقت ممكن وتسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين.
17- تولّي مؤسسة العدالة الانتقالية مسائل محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وكل ما يلزم من عمل وإجراءات تساهم في معالجة إرث الفظائع الشّنيعة.
18- القطع مع كل ما يمت بصلة للدولة الشمولية والاستبدادية، ورفضُ اللجوءِ إلى العنفِ، وتحييد مؤسسات الجيش والأمن والقضاء عن السياسة.
19- إعادة النظر في مناهج التربية والتعليم، وإزالة آثار التعصب القومي والفئوي والحزبي من المناهج والكتب وتنقيتها من شوائب التحريف والتعمية والكراهية.
20- إصلاح التعليم العالي وربطه بحاجات البلاد وإمكانياتها وآفاق تطورها.
المادة الخامسة: رؤية الحركة فيما يتعلق بالنظام السياسي في سوريا: - سوريا دولة اتحادية (فيدرالية) يتم فيها توزيع السلطة والموارد بين المستويات الاتحادية والإقليمية. وترى الحركة أن اللامركزية السياسية هي الشكل الأنسب لبنية الدولة بحيث يتم توزيع المحافظات السورية على عدد من الأقاليم بعد إعادة النظر في الحدود الإدارية لبعض المحافظات وتعديل ما يلزم منها لضمان الانسجام والاستقرار.
المادة السادسة: اسم الدولة: جمهورية سوريا الاتحادية، أو الجمهورية السورية.
على ان يتم مراعاة التنوع السكاني بشكل مناسب عند وضع واختيار اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني وغيرها من رموز الدولة ومؤسساتها
المادة السابعة: نظام الحكم: جمهوري برلماني، على ان تكون سوريا دولة ديمقراطية ذات سيادة، تنبثق سلطاتها من إرادة الشعب، وان تكون دولة قانون تحترم الحريات وتحمي الحقوق، وتلتزم بمبادئ سيادة القانون وفصل السلطات واستقلالية القضاء، وان تقوم بمحاربة الفساد وتتخذ الاجراءات للوقاية منه.
المادة السابعة: مبادئ دستورية
1 – يعترف دستور الدولة بتنوعها السكاني ويضمن حمايته. وتتمتع جميع المجموعات – بغض النظر عن حجمها العددي – بحق احترام وحماية حقوقها بشكل عادل وصيانة وتعزيز هويتها الثقافية.
2- تسترشد سلطات الدولة في عملها بمقاييس الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية وتحترمها.
3- يضَـمِّن الدستور حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الشرعة الدولية، وتلتزم جميع السلطات والمؤسسات التي تؤدي وظائف الدولة بتلك الحقوق، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وخاصة لجهة مراجعة القوانين القائمة وتعديلها وسَن قوانين جديدة وتخصيص الموارد المالية ووضع الخطط الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان وتحسين ممارستها وتطبيقها.
4- يضمن الدستور المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، كما يضمن أيضاً تمثيل النساء ومشاركتهن بصنع القرار في جميع مؤسسات الدولة السورية بشكل مناسب. ويتم مبدئياً تمثيل النساء في جميع المؤسسات ومراكز صنع القرار على المستويين الاتحادي والإقليمي بنسبة لا تقل عن ٣٠٪، مع العمل على وصولها حتى النصف.
5- يضمن الدستور المشاركة العادلة في سلطات وأجهزة ومؤسسات الدولة وعلى جميع مستويات وذلك لجميع المجموعات السكانية، كما يؤمّن تكافؤَ الفرص بين جميع المواطنين وفي كافة المجالات.
6- يضمن الدستور علمانية الدولة، بما يعني ضمان حرية المعتقد والضمير للجميع وحيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات جميعها.
7- يكون حق التقاضي مكفولاً، ولا يشمل التقادم أياً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، كما يمكن للقضاء الوطني النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم المذكورة بغض النظر عن جنسية الفاعل أو الضحية أو مكان إقامتهما أو مكان ارتكاب الجريمة.
المادة الثامنة: القضايا المتعلقة بالفهم اللامركزي للدولة ومبدأ توزيع السلطات بين المركز والأطراف
تنحصر مسؤولية المستوى الاتحادي المركزي بموجب الدستور، بــالتالي:
1 – الجيش، الدفاع، الأمن الوطني، وحماية الحدود (بالتعاون مع الاقاليم).
2 – الشرطة الاتحادية التي تحمي الدستور وتضمن التعاون مع الشرطة الدولية.
3 – العملة الوطنية والبنك المركزي المستقل.
4 – الجنسية.
5 – العلاقات السياسية الخارجية.
6 – قوانين: العقوبات، الملكية، العقود والتجارة، تحصيل الديون والإفلاس، البنوك والبورصة.
7 – معايير التنمية الاقتصادية والضمان الاجتماعي، والتنسيق في هذا المجال مع الأقاليم بشكل وثيق.
أما المهام المتبقية للدولة فتدخل ضمن اختصاص الأقاليم. وتتمثل في
التربية، التعليم، الرعاية الصحية، الشرطة المحلية، تنظيم الأحوال الشخصية والأسرة والإرث، البنى التحتية للإقليم وكذلك التنمية الثقافية، وحماية البيئة والتراث الثقافي.
على ان تتعارض الدساتير والقوانين الإقليمية مع التشريعات الاتحادية ولا يجوز أن تتعارض الأخيرة مع اللوائح والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها. كما لا يجوز تقييد أو إلغاء المبادئ الدستورية التالية: الديمقراطية، دولة القانون، حقوق الإنسان، حقوق المجموعات العرقية والدينية والمذهبية واللغوية، دولة الرعاية الاجتماعية، اتحادية الدولة.
الى جانب ذلك تكفل الدولة بسلامة ومتانة البنية الأساسية وإمداد جميع السكان بالماء والطاقة ووسائل الاتصالات، كما تضمن الدولة أعلى قدر ممكن من الضمان الاجتماعي. وتوفر التأمين للمسنين وغير القادرين على العمل وتأمين البطالة والتأمين الصحي.
ثانياً – على صعيد كوردستان سوريا:
1- مبادئ أساسية: - الاعتراف المبدئي بحق تقرير المصير للشعب الكوردي في سوريا.
- ضمان اتحادية الدولة السورية، واعتبار كوردستان سوريا وحدة فيدرالية فيها.
- يضمن الدستور أن القرارات الصادرة بالأغلبية من قبل السلطات الاتحادية بصدد كوردستان سوريا لن تؤثر على/في حقوق الأخيرة وفيما يقرره لنفسه الشعب في إقليم كوردستان سوريا.
- لا يجوز فرض قانون للانتخابات على الأقاليم دون موافقة منها.
2- المهام المرحلية: - مواجهة الانتهاكات المرتكبة في مناطق كوردستان سوريا وجميع مرتكبيها أينما كانوا والعمل على ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ومن خلال الآليات الدولية ذات الصلة.
- العمل على تأمين حماية دولية لمناطق كوردستان سوريا وضمان إدارتها من قبل أهلها.
- سلوك سبيل الحوار بين القوى السياسية الكوردية الموجودة على الأرض للوصول إلى اتفاق كوردي يضمن تأمين حماية واستقرار هذه المناطق وإعادة النظر بالأساس القانوني والهيكلي لإدارة المنطقة من مختلف جوانبها وتشكيل إدارة جديدة لكوردستان سوريا، بآليات ديمقراطية وعبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع المكونات، وبرعاية وإشراف دوليين، بما يضمن استقلالية قرارها وسلامة موقعها في المعادلة السياسية الوطنية والإقليمية وإنجاز حالة تلبي تطلعات الشعب وتمنع الذرائع عن الجهات المتربصة وتؤسس لعلاقات طبيعية مع الجوار الإقليمي.
- رفض التغيير الديمغرافي والعمل على توفير بيئة آمنة تضمن عودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي وكريم.
- الاهتمام بمكونات المجتمع الأخرى في كوردستان سوريا، وإقامة أفضل العلاقات مع تعبيراتها السياسية والمدنية.
- العمل على صيانة السلم الأهلي والاجتماعي ونبذ التوترات القومية والطائفية والمذهبية.
- إلغاء كافة القوانين والمراسيم والتعاميم والسياسات والمشاريع الشوفينية المطبقة بحق الشعب الكوردي، ولاسيما مشروعي الحزام العربي، والإحصاء الاستثنائي ومجمل سياسات التعريب التي طالت مناطق التواجد الكوردي، ومعالجة أثارها وتعويض المتضررين منها، والعمل على إعادة الأوضاع الى ما كانت عليها سابقاً قبل تطبيق تلك السياسات.
- العمل على معالجة الآثار الناجمة عن سياسات التعريب، من خلال تطبيع الأوضاع في جميع المدن والقرى الكوردية التي أجبر سكانها على مغادرتها تحت أي ظرف كان، وإعادة جميع الأراضي والممتلكات إلى أصحابها ومستحقيها الأصليين وإلغاء جميع القوانين والقرارات التي استملكت وصودرت بموجبها تلك الأراضي، وتعويض المتضررين من تلك السياسات، وإعادة السجلات المدنية للمستوطنين إلى أماكنهم السابقة، وإعادة واعتماد الأسماء الأصلية لجميع المدن والبلدات والقرى والأماكن التي تمّ تغيير أسمائها، وإعادة الجنسية السورية إلى جميع من جردوا منها وكذلك إلى جميع المكتومين، وتعويض المتضررين من عملية التجريد من الجنسية وما تبعها من تداعيات.
ثالثاً – في الجانب القومي الكردستاني - تدعم الحركة وتتضامن مع نضال الشعب الكوردستاني في الأجزاء الأخرى من كوردستان، بالوسائل السلمية الديمقراطية بعيداً عن العنف، من أجل نيل حقوقه القومية المشروعة، وفق العهود والمواثيق الدولية ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
- تؤمن الحركة وتعمل على تمتين الأواصر الاجتماعية والثقافية والسياسية بين الكورد في جميع أجزاء كوردستان وفي بلدان الشتات والمهجر.
- تسعى الحركة إلى حماية وتطوير اللغة الكوردية ودعم الكتابة والإبداع بها واستخدامها في جميع المجالات.
- ترى الحركة أن ما تحقق من منجزات في إقليم كردستان العراق كان نتاجاً طبيعياً لتضحيات الأشقاء في ذاك الجزء، وتعد مكسباً قومياً للأمة الكوردية يستوجب دعمها وحمايتها.
- ترى الحركة أن نتائج الاستفتاء الذي جرى في أيلول 2017 كانت محاولة مشروعة وجادة في سياق حرية تقرير المصير لشعب كردستان العراق وفق العهود والمواثيق الدولية، ولا بد من الأخذ بها واعتبارها وثيقة هامة واستخدامها في المحافل الدولية كتعبير حقيقي عن رأي غالبية شعب الإقليم، وكانت بالأساس قراراً نابعاً من جهة شرعية منتخبة وهي برلمان إقليم كردستان.
- تعتبر الحركة أن ما تحقق من خطوات توحيد قوات البيشمركة في الآونة الأخيرة هو انجاز تاريخي يجب دعمه بكل السبل. المادة العاشرة: في الجانب الاقتصادي
ستعمل الحركة ومن خلال المؤسسات الوطنية المعنية من أجل تضمين الدستور السوري القادم مضامين البنود الاقتصادية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (وخاصة المواد من ٢١ إلى ٢٧) الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في ١٠ كانون الأول ١٩٤٨ بوصفه المعيار المشترك بين كافة الشعوب والأمم، حيث يحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً وبالتالي ينبغي أن يكون الدستور الجديد لسوريا واضحاً لجهة التزامه بالإعلان وكذلك بالعهود والاتفاقيات الدولية في هذا الجانب. كما يجب أن يتضمن – الدستور السوري الجديد في جزءه الاقتصادي – أن جميع الثروات سواء التي في باطن الأرض أو في ظاهرها بما في ذلك المياه الإقليمية وما تحتويها هي ملـك للشعب السوري، ويتم استغلالها لحاضره ومستقبله. وكل التنقيبات التي تدخل فيها الشركات الأجنبية يجب أن يكون للسوريين فيها الحصة الأكبر وضمن إطار زمني محدد، وأن تدخل في خزينة الدولة وفق معايير وضوابط قانونية واضحة. وأن يكون أساس الاقتصاد الوطني هو العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق بين أبناء الشعب. وأن يكون منتجاً وتنافسياً في إطار التنمية ومراعاة الحفاظ على البيئة، والسوق الحر وتشجيع الاستثمار. وضرورة أن تعمل الحكومات المقبلة على وضع خطط تنموية لزيادة المدخرات الوطنية والإنتاج وضمان استقرار الأسعار وتأمين فرص العمل لدعم الخدمات وحماية حقوق المستهلك، والعمل على وضع خطط بعيدة المدى للقضاء على التفاوت الكبير بين الريف والمدينة في مختلف المجالات وخاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. وبناء اقتصاد وطني متنوع وحمايته ودعم القطاع الخاص والمشترك وذلك بالاستفادة من كافة القدرات الوطنية، وإيلاء اهتمام خاص بالقطاعين الصناعي والزراعي والاستفادة من التقنيات الحديثة، وصيانة الملكية الخاصة وحمايتها، ودعم الطبقة الوسطى كونها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية. وتنظيم الضرائب بالشكل الذي يتناسب مع مستوى المعيشة ومقدار الدخل وإعفاء الشرائح التي تواجه مصاعب في تأمين متطلبات الحياة وكل ذلك بمقتضى القوانين الناظمة والآليات الكفيلة بضمان استخلاصه ووضع حد للمتهربين منها. ضرورة إيجاد آليات واضحة للتصرف بالمال العام ومراقبة ذلك من قبل الهيئات المختصة، وأن الدولة السورية المستقبلية تكفل الحقوق الاقتصادية لكل مواطن إلى جانب الحقوق الأخرى، وكذلك الضمان الاجتماعي لكل مواطن في حالات الشيخوخة والمرض وفي الحالات القاهرة الخارجة عن إرادتهم. وحق العمل لساعات محددة وضمان السلامة والحد الأدنى للأجور الكفيلة بتأمين العيش الكريم والصحة للعاملين وأسرهم، وكذلك إجازات الأمومة والطفولة.